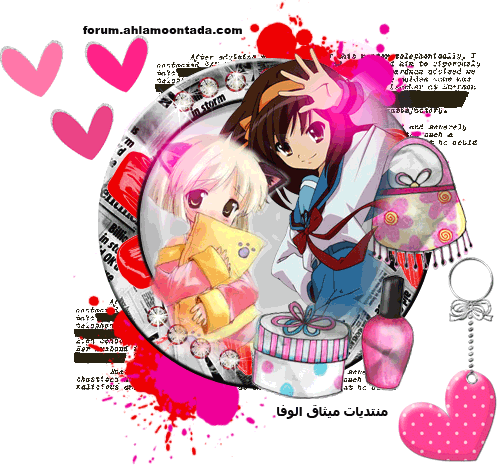احمد الساري
مشرف


عدد المساهمات : 146
نقاط : 49428
تاريخ التسجيل : 19/06/2011
 |  موضوع: السياسة اليوم موضوع: السياسة اليوم  الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 7:52 pm الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 7:52 pm | |
| [b][b][b][b]عاد سؤال السياسة من جديد اليوم للتطارح وللنقاش
العمومي، لكن بصيغة سؤال السياسة اليوم، في شكل إحالة الى القولة المأثورة
"حنا أولاد اليوم"، وذلك بعد أن خفت هذا السؤال لمدة ليست بالقصيرة. تدفعنا
هذه العودة لسؤال السياسة اليوم الى طرح جملة من الملاحظات بخصوص واقع
السياسة، ليس في صيغة سؤال السياسة اليوم، باعتباره سؤالا يستبطن ضيقا في
الأفق والإستراتيجية، بل بما تعنيه هذه السياسة من حراك ونقاش عمومي تفرضه
جملة من المستجدات الوطنية والحاجات المجتمعية - بما هي ضرورات تاريخية -
في بعدها الاجتماعي والثقافي والديمقراطي.
فسؤال السياسة، بهذا المعنى
الواسع غير المحدد باليوم أو بالغد، لا ينبغي أن ينبع من اكراهات ظرفية،
رغم أهميتها، بل ينبغي أن يطرح بأفق الإجابة على الأسئلة الحقيقية والمقلقة
التي، بتمظهرها في صيغة سؤال السياسة اليوم، تبدو كما لو أنها تعالج بعض
المشاكل الظرفية والسطحية، أي الإجرائية. إن طرح الإشكالية في صيغة سؤال
السياسة اليوم هو أقرب ما يكون الى الظرفية السياسية الراهنة التي هي لحظة
ما قبل انتخابية بامتياز، مع ما تعنيه تلك اللحظة من دق طبول الحروب
الكلامية والصراعات الإعلامية والتنظيمية التي تخترق المشهد الحزبي الذي
صار مشهدا انتخابيا مناسباتيا لا هم لأطرافه إلا تحصيل أكبر عدد من
المقاعد، بالرغم من أن تلك المقاعد لم تعد تعبر سوى عن أقلية من الشعب
المغربي.
لا يمكن تناول سؤال السياسة بشكل عام، أو سؤال السياسة اليوم
بشكل خاص، إلا من خلال إثارة إشكالية رئيسة تتوزع، على الأقل، الى ثلاث
مستويات هي في غاية الترابط وفي غاية الأهمية: أولا من خلال الوقوف على ما
تعنيه السياسة، اليوم، في ظل عزوف جماهيري لا نراه إلا متزايدا، من استحقاق
الى أخر، ثم ثانيا من خلال إثارة موقع وموقف الأحزاب -
الحكومية والمعارضة - من السياسات الاستراتيجية الرئيسة التي ترسم مستقبل
البلاد، والتي ينبغي أن تكون محل نقاش وطني عميق، سواء تعلق الأمر بالأوراش
الكبرى ومن هم الفئات الأكثر استفادة منها في ظل عدم تحسن الأوضاع
الاجتماعية للفئات الأكثر تهميشا من تلك الأوراش، أو بالقضايا الوطنية
المصيرية، من قبيل قضية الوحدة الترابية والقضية الأمازيغية على سبيل
المثال لا الحصر، وأخيرا/ثالثا من خلال طرح إشكالية استكمال بناء الدولة
المغربية التي هي، في اللحظة الراهنة، في محاولة انتقال تاريخي واجتماعي،
بنيوي ووظيفي، معقد من دولة مركزية أقرب ما تكون الى النموذج الجاكوبيني (
(pseudo- jacobien الى دولة عصرية ينبغي لها أن تقوم على أساس من
اللامركزية واللاتمركز، وذلك من خلال سيرورة إرساء الجهوية الموسعة لمختلف
جهات البلاد، مع منح حكم ذاتي للصحراء المغربية - الصحراء الغربية على حد
توصيف البام - قمين بحل مشكلة الصحراء حلا ديمقراطيا ووطنيا، ومن شأنه وضع
حد لمعاناة الصحراويين المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف (للاطلاع على
شهادات حية من هذه المعانات يمكن الرجوع الى كتاب صدر مؤخرا بعنوان "الخروج
من ثم الثعبان" لكاتبه الأستاذ أحمد الجلالي).
عود على بدء، إذا نحن
أخذنا مأخذ الجد هذه المستويات الثلاث، فان سؤال السياسة اليوم يبدو أكثر
غموضا وتعقيدا عما تقدمه الأحزاب، بمختلف توجهاتها، التي لا ترى في سؤال
السياسة سوى ذلك الشق التنظيمي المتعلق بالانتخابات التي تفرز تشكيل
البرلمان والحكومة. إن سؤال السياسة اليوم، وهو يتجاوز هذه
النظرة الحزبية الضيقة، وهو يطرح كذلك إشكالات اجتماعية وثقافية
وإستراتيجية كبرى تمس قضايا المجتمع المغربي المصيرية، انه - أي سؤال
السياسة - وهو يطرح كل هذه الإشكالات ليس سوى سؤال الدولة التي بشأنها يجري
حراك اجتماعي وصراع سياسي، في شكل نقاش عمومي، بغاية ترجمة ذلك الصراع الى
نوع من التوافق على طبيعة وماهية هذه الدولة وكذا كيفية إعادة بناءها.
ما
يعني أن ذلك الصراع/التوافق يستلزم بالضرورة الانخراط في نقاش مجتمعي حول
مفهوم وأسس هذه الدولة التي يتغيى المغاربة التوافق عليها، وهذا طبعا له
رهاناته واستحقاقاته المرتبطة بتعديلات دستورية تروم إرساء عقد اجتماعي
سياسي ثقافي بمضمون ديمقراطي، تعددي وحداثي يقطع، وينهي، مع تلك الأسس
الإيديولوجية، ذات المضامين البرجوازية، وذات الشعارات الإصلاحية
والعروبية، التي استندت إليها أحزاب الحركة الوطنية منذ ثلاثينيات القرن
الماضي في ممارساتها السياسية الطبقية البرجوازية التي رهنت، لعقود، انتقال
المجتمع والدولة، معا، من حالة الغموض والتخلف والصراع وهيمنة طبقات/فئات
معينة على أخرى الى حالة من التقدم والديمقراطية وجبر ضرر الفئات والطبقات
والمجالات المتضررة من السياسات المتبعة، منذ الاستقلال الى يومنا هذا.
هذه
هي الإشكالية المركزية التي ينبغي تعميق النقاش فيها، باعتبارها جوهر
السياسة اليوم ببلادنا؛ ورغم ما لهذه الإشكالية من أهمية قصوى، إلا أن
الأحزاب، جميعها، تخلت عن مثل هذا النقاش السياسي والتاريخي، بحيث تراها،
اليوم، لا تنخرط في أي نقاش سياسي عميق، ولا تطرح أية مبادرة للنقاش
العمومي، إلا إذا تلقت الإشارة من فوق، أي من طرف الدولة، أو قل من طرف
أجهزة من الدولة. وما الأمثلة على ما نقول بقليلة، ذلك أن قضية أميناتو
حيدر تظل أبرز واقعة تدلل على انتظارية الأحزاب وعلى عدم قدرتها على اتخاذ
مواقف سياسية وإستراتيجية غير تلك التي تأتيها من فوق.
ما من أحد منا
إلا واستحضر في، هذا الصدد، كيف أن الأحزاب التي كانت "راديكالية" و"حازمة"
و"وطنية" في مساندة قرار الدولة القاضي بطرد أميناتو حيدر من دون إبداء
وجهات نظرها الخاصة بها، بل ومجندة وراء قرار الدولة رغم ما شاب ذلك الطرد
من إخلال بالقانون الجاري به العمل، بما يعنيه ذلك من إخلال بدولة الحق
والقانون. على أن من يتذكر منا تلك المساندة اللامشروطة لا بد وأن يتذكر
معها في الآن نفسه كيف جرى ذلك الانقلاب المفاجئ في مواقف الأحزاب التي
صارت تؤيد عودة أميناتو حيدر بعد أن اتخذت الدولة قرار السماح المفاجئ
بعودتها....
الأنكى من ذلك أن هذه الأحزاب لم تدخر لا جهدا ولا سفسطة
في محاولة منها تبرير ذلك القرار المفاجئ بالعودة المفاجئة.... ما كان لدى
الأحزاب من "راديكالية" ومن "صرامة" ومن "حزم" صار، بقدرة قادر، ليونة
و"واقعية سياسية" و"تفهما" للضغوط الدولية وحفاظا على المصلحة
"الوطنية"!.... أين هي إذن الوطنية الحقة من هذه المواقف المتناقضة!?...
أهي في مساندة قرار الطرد أم هي في العدول المفاجئ عنه وتبني قرار
العودة?!.
في هذا السياق أيضا لا بد من التذكير بمواقف الاحزاب من
التوتر الأخير بين المغرب واسبانيا اثر الأحداث التي عاشتها مدينة مليلية
المحتلة؛ ذلك أن هذه الأحزاب ظلت تنتظر كعادتها حتى تتبين الإشارة من فوق
لتشرع في ما بعد في تدبيج افتتاحيات جوفاء على جرائدها الحزبية في معاني
ودلالات "الوطنية". ما لا تعلمه هذه الأحزاب أن مثل هذه الممارسات
الفلكلورية لا تزيد إلا في عزلتها وفي انكماش عدد قراء جرائدها، والتي هي
بالمناسبة تتلقى دعما من أموال دافعي الضرائب الذين ينبغي بالمقابل خدمتهم
عن طريق ممارسة خط إعلامي صريح وليس خط تبريري ديماغوجي.
لقد أتينا على
ذكر مثل هذه الوقائع ومثل هذه المواقف السياسية الحزبية المتذبذبة، لا
لشيء، بل وبكل بساطة لأن في ذكر ذلك تنكشف أهمية طرح سؤال السياسة اليوم،
وتحديدا في علاقته بالمستوى الثاني الذي ذكرنا، أي بمواقف الأحزاب من
السياسات العمومية للدولة ومن القضايا المصيرية للبلاد باعتبارها قضايا ظلت
منفلتة عن النقاش الحزبي، وبالتالي عصية عن اتخاذ مواقف سياسية مستقلة
فيها، سواء على المستوى الحزبي، أو البرلماني بما هو تشريعي وبما هو
معارضة، أو الحكومي بما هو تنفيذي وبما هو ضرورة اتخاذ الحكومة لقرارات
تلزم الدولة وليس العكس، كما هو معمول به في الديمقراطيات العريقة.
بمعنى ما، فان الاحزاب سواء تلك الممثلة في المعارضة أو تلك المتموقعة في
الأغلبية الحكومية، منذ زمن "التناوب التوافقي"، ليس لها اظافات نوعية
تقدمها في القضايا الأساسية للبلاد؛ ذلك أنه لم يعد للأحزاب الحكومية من
وظيفة سوى أجرأة وتنزيل بعض القرارات العليا، وليس كلها طبعا، أو قل في
أحسن الأحوال إبداء وجهات نظرها في جزئيات وتفصيلات لا تغير شيئا من طبيعة
القرارات الاستراتيجية المتخذة من خارج الحكومة وبعيدا عن الأحزاب، أي
بمعنى آخر بعيدا عن مسلسلات الانتخابات والاستحقاقات التي، وبسبب من هذه
الإشكالية/المفارقة بالذات، دأبت الأغلبية الشعبية على مقاطعتها.
هذه
هي الحقيقة التي لا تقوى الأحزاب على الاعتراف بها، فتراها، عوضا عن
الاعتراف بهذه الحقيقة، تسترسل في الإتيان بحجج ديماغوجية كلما تعلق الأمر
بنقاش أزمة السياسة والعزوف الجماهيري عن الانتخابات. إن ما تبقى من مهام
إجرائية للأحزاب الحكومية يجعل من "مناضليها" الوزراء عبارة عن تقنوقراط
جدد، لكن مع نقص في الخبرات وفي التخصصات التقنية التي تتوافر في معشر
التقنوقراط الحقيقيين.
لا فرق، والحال هذه، بين "اليمين" أو ما كان
يصطلح عليه سابقا أحزاب الإدارة - للإشارة فهذا مصطلح لا
معنى سياسي له في اللحظة التاريخية الراهنة - وبين الوسط الذي لم يعد
ما به يكون وسطا، وبين اليسار الذي انجر، تحت نزعات البرجوازية الصغيرة
فيه، الى نقيض ما كان يصدر عنه من إيديولوجيات اشتراكية، قومية، شعبوية
وبلانكية. كل هذا الفسيفساء الحزبي صار اليوم لا يقوى على اتخاذ أي موقف
صريح مخالف لمواقف الدولة، تحت يافطة التوافق التاريخي مع المؤسسة الملكية،
بل انه - أي ذلك الفسيفساء - صار عاجزا عن اتخاذ أي موقف رزين ومستقل، إلا
إذا تبين له الخيط الأبيض من الأسود، طبعا من الدولة...
آنذاك تجد كل
مكونات ذلك الفسيفساء تنبري الى ترديد نفس مواقف الدولة مع كثير من التجميل
والتبرير. تلك هي الوطنية عند الأحزاب التي تراها اليوم تحرم كل اختلاف
وتعدد في الرأي، إنها بذلك لا تفعل سوى تنميط الحياة السياسية التي انفك من
حولها ذلك الجمهور العريض الذي كان بالأمس القريب منشغلا ومنخرطا في
السياسة وفي صنع أحداثها الكبرى (إضراب 14 دجنبر 1990 نموذجا).
وبالعودة
الى مقولة التوافق التاريخي للأحزاب مع المؤسسة الملكية، لا بد لنا من
تفكيك هذه المقولة حتى تتكشف كل مكنوناتها؛ ذلك أن التوافق التاريخي الحاصل
في اللحظة التاريخية الراهنة إنما هو توافق بين مجموع الشعب، الذي تراه
ينبذ السياسة في صيغتها الحزبية وبما هي ممارسة نفعية وانتهازية وذات محتوى
عشائري وقبلي متخلف، وبين الملك الذي ما أن يزور إحدى البلدات حتى يحاط
بالشعب الذي ينبغي أن نعترف له اليوم أنه أساس ذلك التوافق التاريخي مع
الملك.
وإذا كان الأمر بهذه الحقيقة، وهو كذلك، فما موقع الأحزاب من
الإعراب، خاصة وأنها لا تتمتع بامتداد جماهيري كبير، وبالتالي ما معنى
التوافق الذي تتغنى به هذه الأحزاب مع الملك?!. نحن لسنا هنا ضد توافق
الأحزاب مع الملك، لكن أن لا تكون للأحزاب امتدادات شعبية واسعة وعريضة
فهذا ما يفقدها الشرعية للحديث عن أي توافق كان. في هذا السياق لا بد وأن
نقف عند الدلالات البالغة الأثر لما جاء في الخطاب الملكي الأخير من أن
استقلال البلاد ساهمت فيه كل مكونات الشعب المغربي سواء في القرى أو في
المدن وهو بذلك ليس مسألة نخبة فقط، انه - أي الاستقلال - بهذا المعنى ليس
حكرا على نخبة الحركة الوطنية كما كان يروج له منذ أمد طويل.
إن ذلك
التوافق الذي تتغنى به الأحزاب ليس ذا أهمية إستراتيجية ما دام أن التوافق
العريض والمحدد والضامن للاستقرار الاجتماعي وللوحدة الترابية والوطنية هو
توافق الشعب المغربي - غير المؤطر حزبيا - مع الملك، وليس توافق الأحزاب
فقط مع الملك. ليس غريبا، والحال هذه، أن تتقدم المؤسسة الملكية، تاريخيا،
على الأحزاب الموغلة في تقليديتها وفي إيديولوجياتها النمطية، بتناولها
لمواضيع ولقضايا حساسة مرتبطة بعمق المجتمع المغربي، ذلك أنها - أي المؤسسة
الملكية - لا تترك أية لحظة تاريخية تمر من دون أن تتخذ مواقف سياسية
وإستراتيجية جريئة (إنشاء هيأة الانصاف والمصالحة وطي صفحة الماضي،
الاعتراف بالقضية الأمازيغية من خلال خطاب أجدير عكس ما كانته مواقف
الأحزاب من هذه القضية، طرح الحكم الذاتي للصحراء، والأمثلة كثيرة).
كل
هذه القضايا المصيرية للشعب المغربي ما كان للأحزاب أن تخوض فيها، وهي
المشغولة بصراعات سياسوية وإيديولوجية لا نفع لها على المجتمع والدولة معا،
لقد جعلوا من التناوب التوافقي لحظة "انتقال ديمقراطي" من دون أن يقووا
حتى على إثارة مثل هذه القضايا الانتقالية والمصيرية للشعب المغربي. إنهم
كانوا يتغيون بذلك طمس بعض من هذه القضايا، وخاصة القضية الأمازيغية،
والتظاهر بانجاز "انتقال ديمقراطي"، لولا أن الشعب المغربي، بعبقريته
المعهودة، فطن لهذه الشعارات الديماغوجية وتصدى لها، من خلال مواقفه
السياسية بمقاطعة انتخابات "الانتقال الديمقراطي" التي هي انتخابات ظلت
تحافظ قسرا على محتواها "التوافقي"، فغيبت بذلك أفقها الاستراتيجي الذي كان
ينبغي أن يكون ديمقراطيا تعدديا وحداثيا.
بهذا المعنى، صرنا اليوم
أكثر تحررا من تلك الطابوهات، بل قل أكثر تفهما لمتطلبات تلك اللحظة
التاريخية التي فيها تم التخلي عن اليوسفي وتعيين جطو مكانه وزيرا أولا
(انتخابات سبتمبر 2002)، والتي كنا فيها آنذاك نخوض نضالات مستميتة كدكاترة
معطلين من أجل الإدماج. بالمناسبة فان التخلي عن اليوسفي وتعيين جطو وزيرا
أولا، وحسب تحليلنا اليوم لتلك المرحلة، ليس تخليا عن المنهجية
الديمقراطية، كما ادعى الاتحاد الاشتراكي في حينه، وإلا لما أقدم هذا الحزب
على المشاركة في حكومة جطو التوافقية. فهل يستقيم الحديث عن المنهجية
الديمقراطية في ظل "التوافق" وفي ظل "اللحظة الانتقالية" التي لم تتحقق
فيها الديمقراطية بعد!?.... لا يمكن الحديث عن المنهجية الديمقراطية إلا
عند انجاز الانتقال الديمقراطي الفعلي، حيث يتم آنذاك إرساء قواعد
ديمقراطية واضحة ومقبولة من جميع الأطراف وتحترم الإرادة الشعبية وتنهي مع
الثقافة السياسية المؤسسة ل"التوافق".
أما توظيف المنهجية الديمقراطية
في سياقات اجتماعية وتاريخية غير مطابقة للحظة الديمقراطية، فهذا ما يمكن
توصيفه اليوم بنوع من المزايدات السياسوية الموجهة آنذاك للرأي العام
وللاستهلاك الإعلامي بغية التغطية على المشاركة في حكومة جطو التي ظلت
تحافظ على الطابع التوافقي المغيب لأي مضمون ديمقراطي، أو قل لأية منهجية
ديمقراطية.
فلتكف إذن هذه الأحزاب عن التغني بأسطوانتها المشروخة هذه
التي تجعل من التوافق التاريخي مع الملك مبرر انتظاريتها ومكمن عجزها عن
طرح أي مشروع مجتمعي، أو برنامج سياسي، أو على الأقل مناقشة ذلك المشروع
الاستراتيجي للدولة بما يفضي الى إدخال وجهات نظر الأحزاب في ذلك المشروع
بغية تطعيمه واغناءه، وهو ما كان سيسمح للسياسة بأن يكون لها معنى نبيل غير
ذلك الذي أضحى يتردد اليوم على مسامعنا من طرف أحد منظري الاتحاد
الاشتراكي. أما هذا المعنى الذي بات يتررد، فليس سوى ما يدعونه "الثقافة
السياسة الجديدة" التي تتمحور أساسا حول انجاز النهضة ((Renaissance أولا
ثم الإصلاح ثانيا، بحكم أن البلاد، حسب عناصر هذه الثقافة الجديدة، تعيش
تأخرا تاريخيا وليس فقط تخلفا مجتمعيا.
إذا كان المجتمع، حسب التوصيف
الراهن لأصحاب الثقافة السياسية الجديدة، يعيش تأخرا تاريخيا يستلزم "نهضة"
ما - وهذه حقيقة ساطعة منذ الاستقلال ما كان ينبغي لأصحاب الثقافة
السياسية الجديدة تجاهلها حتى اليوم - فلماذا لم يأخذ الاتحاد الاشتراكي
هذا التأخر التاريخي بعين الاعتبار يوم قبل المشاركة في التناوب التوافقي،
ويوم كان يدعي انجاز الانتقال الديمقراطي، ويوم تراجع عن المطالبة بإرساء
"المنهجية الديمقراطية" برغم ما تستبطنه هذه المقولة من إشكالات ذكرناها
آنفا?!... أين كان دعاة هذه النهضة، التي هي بالمناسبة لن تكون سوى عروبية
جديدة-قديمة، زمن التناوب التوافقي? ذلك الزمن الذي مجدوه ورفعوه الى مستوى
اللحظة الحاسمة في تطور المجتمع المغربي، باعتباره "لحظة الانتقال
الديمقراطي".
هل كانت الحاجة المجتمعية والتاريخية ستبقى قائمة الى نوع
من "النهضة" لو تحقق فعليا الانتقال الديمقراطي الذي هو تاريخيا يشكل طورا
أعلى من طور النهضة المزعومة? نحن اليوم في سياق تاريخي كوني لم تعد فيه
للنهضة تلك الجاذبية ولا تلك الحاجة الموضوعية، خاصة إذا كانت نوعا من
التجديد الإيديولوجي للايدولوجيا العروبية القومية التي ينبغي النأي
ببلادنا عنها وعن تبعاتها الكارثية؛ تاريخيا كانت مراحل النهضة في
المجتمعات الغربية سابقة عن أطوار الانتقالات الديمقراطية، وهذا التسلسل
التاريخي لا نخاله إلا منسحبا على تطور باقي الشعوب، رغم تميز شروطها
الاجتماعية وظروفها التاريخية. لذا فان تطور المجتمع المغربي، في
تميزه/خصوصيته، ليس تطورا منفلتا عن الشرط الكوني العام ولا عن حتمية
التطور التاريخي للمجتمعات البشرية، طبعا مع وجود تمايزات عينية بين تجارب
الشعوب..
هكذا تصير الحاجة الى النهضة بعد استيفاء "الانتقال
الديمقراطي" ضربا من الوهم والخيال، إن لم نقل من الديماغوجية. هنا تنكشف
غرابة هذه الإيديولوجيات البرجوازية الصغيرة القومية التي ما انفكت، من
لحظة تاريخية الى أخرى، تتخذ شكلا جديدا-قديما، من دون أن تقوى على مباشرة
نقاش موضوعي لأن في ذلك ينكشف أمرها، أو قل ما تبقى من أمرها.
ما من
كلام إيديولوجي وما من مساحيق إعلامية حول الانتقال الديمقراطي إلا وسيق
أيام التناوب، من طرف الاتحاد الاشتراكي (جريدة الاتحاد الاشتراكي) وبعض
القوى الملتفة حوله (دفاتر سياسية نموذجا)، حتى أنهم جعلوا من التناوب
التوافقي زمنا للانتقال الديمقراطي؛ لكن ما أن جاءت لحظة التخلي عن
"المنهجية الديمقراطية" حتى صار كل حديث عن الانتقال الديمقراطي مجرد أضغاث
أحلام.
بذلك فانه - أي الانتقال الديمقراطي - ليس سوى أدلوجة تفنن
الاتحاد الاشتراكي، ومن يدور في فلكه من اليسار العروبي، في استعمالها
إعلاميا للتغطية على ذلك التحول الكبير الذي حصل في الخط السياسي لحزب
"القوات الشعبية" الذي صار ليبراليا، إن لم نقل ليبراليا متوحشا، بسبب من
استفادة البرجوازية الصغيرة فيه من زمن التناوب واستحقاقاته، حتى إذا صارت
هذه البرجوازية الصغيرة برجوازية مخزنية، لم يعد لها من مانع للانخراط في
الطرح الليبرالي والابتعاد عن المشروع "الاشتراكي" الذي فيه انخرطت، ومن
أجله ضحت، قوات شعبية عديدة في محاولة تاريخية لإقرار الديمقراطية والعدل
الاجتماعي قبل أن تستفيق على طبيعة ذلك المشروع البرجوازي الصغير الطامح
الى الترقي الاجتماعي والسياسي والى طمس كل تنوع ثقافي وحضاري لبلادنا....
ليست هذه الممارسات السياسية والإيديولوجية سوى تعبيرا عن سلوكات
البرجوازية الصغيرة عبر تاريخ الشعوب، فهي تتخذ لنفسها إيديولوجيات قومية،
شعبوية، راديكالية، بلانكية وحتى اشتراكية، لكن ما أن تصل الى السلطة حتى
تتماهى مع أمر الواقع، أو قل تحاكيه، فتتنكر بعد ذلك لكل تلك الإيديولوجيات
التي كانت حاملة لها في السابق. وما ذلك بغريب في تاريخ المجتمعات التي
فيها كانت دائما مواقف البرجوازية الصغيرة متذبذبة بين طموحها في أن تصير
برجوازية مسيطرة وبين شعاراتها الإيديولوجية الرنانة في الدفاع عن مصالح
الطبقات الشعبية.
لذا ليس غريبا اليوم أن نسمع ونقرأ مثل هذا السؤال
بخصوص ماهية السياسة اليوم والذي جاء هذه المرة في ثوب إيديولوجي جديد-قديم
ألا وهو ثوب النهضة والإصلاح؛ الحقيقة انه لا يمكن القيام لا بالإصلاح ولا
بالنهضة- حتى إن افترضنا ذلك ضرورة تاريخية- ما دام الشعب بعيدا كل البعد
عن العمل السياسي الحزبي في مأزقه الراهن؛ انه، أي ذلك المأزق، ليس سوى
إحدى عناوين ما ينبغي أن يكون عليه سؤال السياسة اليوم
[/b][/b][/b][/b] | |
|